معرفة للتحرر- قواعد ومراجعات في عالم متغير
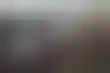
ما الذي يمكن أن يضيفه مُعمَّر مثلي، تجاوز الستين ربيعًا هذا الأسبوع، من رؤى فكرية وسياسية ثاقبة حول الأحداث المتسارعة في مصر، والإقليم، والعالم أجمع؟
لقد كانت هذه الذكرى بمثابة سانحة ثمينة لإجراء تقييم شخصي لما سطّره قلمي على مدار السنوات الخمس المنصرمة -حقبة ما بعد التجربة المريرة في السجن- والتي تجسّدت في خمسة مؤلفات، فضلًا عن المشاركة في كتاب جماعي احتفاءً بمرور عقد على الانتفاضات العربية.
ظلّ الهاجس المسيطر عليّ، وأنا أكتب بانتظام أسبوعيًا خلال هذه السنوات، هو ألا أكون سندًا أو معينًا للمستبدّين. ومن خلال تجربتي في الأعوام الماضية، تبيّن لي أن مفهوم الاستبداد يكتسب بعدًا شاملًا في حياتنا، ولا يقتصر فقط على تغوّل السلطة العليا في الدولة واستبدادها؛ بل يتغذّى أيضًا على تفشّيه في جميع مناحي حياتنا. إنه يظهر في المجال الاقتصادي، كما يتجلّى في طبيعة العلاقات بين الرجل والمرأة في المجتمع. فالاستبداد متغلغل في هياكل توزيع الثروة والموارد، وبين ذوي النفوذ الذين يستأثرون بها ويحوّلونها إلى دولة داخل دولتهم، ممّا يحرم قطاعات واسعة من المجتمع من حقّها في العيش الكريم.
هل ما ننتجه من معرفة، أو نسهم به في إثراء النقاش العام، يصبّ في دعم الهياكل التسلطية التي أحاطت بنا من كل جانب، ولم تترك زاوية إلا واحتلتها؟ أم أننا نساهم في تقويض هذه الهياكل وتفكيكها؟
قواعد أساسية في إنتاج المعرفة من أجل التحرر والإنعتاق
أولًا: استيعاب كُنه المشكل التاريخي
المشكل، كما تجلّى بوضوح في العقد الماضي، يتمحور حول إعادة بناء الدولة الوطنية عبر تجديد أصولها وإصلاح هياكلها، وذلك من خلال إرساء نظام ديمقراطي تشاركي تعدّدي، قادر على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحقيق تحرير الإرادة الوطنية من براثن شبكات المصالح المتشعبة في هياكل الدولة.
إن المعضلة التاريخية الراهنة تتمثّل في المسألة الديمقراطية بجناحيْها: السياسي والاجتماعي، والتي لا يمكن تحقيقها إلا في سياق تحرير الإرادة الوطنية من الهيمنة الإقليمية والدولية.
أما المشكل التنظيمي، فيكمن في وجود حركات وطنية ديمقراطية ذات مرجعيات فكرية متنوعة ومتباينة.
إن القراءة التاريخية لانتفاضات الربيع العربي -التي تُعدّ "طوفان الأقصى" موجة من أمواجها المتتالية التي لم تنتهِ بعد- تشير إلى أننا نشهد إعادة تشكيل للتاريخ برمته في المنطقة، وأننا نقف على أعتاب محطة تاريخية فارقة.
ثانيًا: المعرفة منفعة عامة للجميع
وهذا يستدعي أن تكون المعرفة وسيلة للتغيير نحو الأفضل لصالح شرائح اجتماعية واسعة. فالمطلوب هو التأثير الفاعل في السياسات العامة، وتوجيه أولويات الإنفاق العام لكي تعبّر بشكل أعمق عن تطلعات عامة الناس واحتياجاتهم الملحّة.
إن ما نشهده اليوم هو تحوّل من التركيز على السياسة بمعناها التقليدي إلى الاهتمام بالسياسات التفصيلية، حيث نرى انتقالًا من السياسة باعتبارها عملية مؤسسية تضطلع بها نخبة محدودة، إلى عمليات سياسية متعدّدة يشارك فيها أصحاب مصلحة كُثر، وهي لا تدور فقط حول قضايا نخبوية، وإنما تشمل جميع الموضوعات التي تؤثر في حياة المواطن اليومية، بدءًا من الخبز ووصولًا إلى الحرب في غزة.
في مجال السياسة، لا يجوز النظر إلى المرجعية بمعزل عن الواقع إطلاقًا، بل يجب النظر إليها من خلال آثارها الواقعية في ظل الظروف الزمانية والمكانية التي نعيش فيها، أو التي مورست فيها، أو التي ستُمارس فيها، لا النظر إليها مجرّدة من الواقع التطبيقي، بل من خلال الأثر العملي للأفكار.
إن المطلوب الآن ليس التنظير في المرجعيات الأيديولوجية والأطر الفكرية العامة، ولكن تقديم سياسات عامة وبرامج مفصّلة من شأنها أن تعالج المشاكل الواقعية التي تواجه الناس، وتجيب عن تساؤلاتهم اليومية.
ثالثًا: ابتداع معيارية جديدة مبتكرة
وهي تتجلّى بوضوح في وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يقتصر دورها على تنشيط الجدل العام الذي تحاول السلطات قمعَه في كل مكان؛ بل يتجاوز ذلك إلى خلق معايير جديدة، يتم من خلالها تقييم المواقف والسلوكيات والسياسات والإجراءات، وتقديم سرديات بديلة تتحدى الروايات السائدة أو المهيمنة، ويتم فيها القضاء على المركزية والمرجعيات والرموز، حيث لا قداسة لأحد، وإنما الفيصل هو القناعة والقبول والنفع والعملية.
نؤكّد أن المعايير المرجعية للسياسة لم تعد أيديولوجية، بل أصبحت يومية وحياتية، ولم تعد ثابتة غير قابلة للتغيير، ممّا أدى إلى تلاشي الإجماع المهيمن أو الرواية السائدة. وأخيرًا، فإن ما يستحق المتابعة هو كيف تتم إعادة صياغة وتشكيل الإطار المعياري في العالم – كما يتضح في ردود الفعل العالمية على الإبادة الجماعية في غزة – بين نموذجين متناقضين: التنوع والتمرد من جهة، والضبط والتحكم من جهة أخرى.
رابعًا: إعادة تشكيل وصياغة النقاش العام بشكل جديد
والمبرّر لهذه الضرورة هو التحوّلات الكبرى التي تشهدها الأوطان، والإقليم، والعالم بأسره.
إن تشكيل النقاش العام يستدعي القيام بأربع عمليات متكاملة:
- التقاط الموضوعات المستجدة، مثل تغيّر هيكل القوى في النظام الدولي، والتطورات التكنولوجية المتسارعة، وتغيّر طبيعة الاقتصاد مع إعادة التفكير في مفهوم العولمة، وتصاعد صوت الأجيال الشابة في السياسة، ووضع القضية الفلسطينية في أفق عالمي يشمل الحقوق والقانون الدولي الإنساني، ويضم مفاهيم العدالة ومناهضة السلطة، ورفض القوة، والاحتفاء بالتعددية بكل أشكالها.. إلخ.
- ضرورة إعادة صياغة الأسئلة والإشكالات وعدم استحضارها بشكل تلقائي: ففي القرن العشرين، حكمتنا ثنائيات متعارضة من قبيل: نحن والغرب، الحداثة والدين. أما الآن، فنحن أمام صيغ جديدة تقوم ببناء شبكتها غير الهرمية واللامركزية على قضايا جزئية محدّدة، مثل: التضامن مع غزة، وحقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، وحماية البيئة.. إلخ.
- الاستدعاء المتواصل لأصوات جديدة للنقاش العام وتمكين الأصوات المهمّشة: إنتاج المعرفة لم يعد عمليّة مركزية حِكرًا على خبراء تلقّوا تعليمًا معرفيًا ومهنيًا محدّدًا؛ بل بات عمليّة لا مركزية يشارك في صياغتها أناس كثيرون من مختلف الخلفيات. لقد أثبت "طوفان الأقصى" قدرة المقاومة على إنتاج التكنولوجيا في ظل قيود مشدّدة وحصار خانق، ممّا مكّنها من تلبية احتياجاتها في مواجهة تكنولوجيا متقدمة لا تملك غير التوحّش والإبادة الجماعية سبيلًا، ورغم ذلك عجزت تكنولوجيا التوحّش عن القضاء على المقاومة، ولا أظنّها ستحقّق ذلك.
- التشبيك: لقد دشّنت تجربة الربيع العربي نوعًا جديدًا من المعرفة لم تعرفه المنطقة العربية من قبل، وهو اشتراك فواعل متعدّدة في إنتاج المعرفة الخادمة للتغيير، حيث يشارك فيها المحلي أكثر من المركز، وينتهجها أهل القرى والأرياف أكثر من المدن والعواصم الكبرى.
خامسًا: التحلّي بشجاعة المراجعة والنقد الذاتي الشجاع
هل نحن بحاجة إلى هزائمَ ونكساتٍ على غرار هزيمة 67، أو تعثّرات في مسار الفترات الانتقالية – كما شهدنا بعد الربيع، أو أزمات وطنيّة شاملة – على النحو الذي نشهده الآن في معظم الدول العربية، أو حروبٍ أهلية مدمّرة …؛ لكي نشرع في إجراء عمليات المراجعة الوطنية الشاملة لجملة القواعد التي قامت عليها الدولة وتأسّس عليها المجتمع، والمسلّمات التي تحكم نظرتنا لأنفسنا وللعالم المحيط بنا؟
صحيح أن الهزائم والتعثّرات والمآزق الوطنية تمثّل أحد الشروط الأساسية للبدء في المراجعات، ولكن السؤال الأهم هو: لماذا لا نمارس عمليات المراجعة بشكل دائم ومستمر؟ ولماذا لا نتجنّب الهزائم والنكسات والأزمات من خلال المراجعة؟ و"النون" هنا تعود على الدولة والمجتمع، والنخب والتنظيمات والكيانات.
تساؤلات أخرى تطرح نفسها: لماذا لا يراكم العرب تجاربهم ولا يتعلمون من أخطائهم التاريخية، أو حتى من الأزمات التي تمرّ بهم، وبالتالي تصبح قدرتهم محدودة على المراجعة ونقد الذات؟ وهل قُدّر لنا أن ندور في حلقة تاريخية مفرغة لإعادة إنتاج النكسات والأزمات والمآزق الوطنية العامة دون هوادة أو توقف؟
متطلبات أربعة أساسية للمراجعة الفعّالة
- استشعار نفسي وقيمي يسود في المجال العام، ويدفع إلى المراجعة دون وجَل أو خوف. ولن يتحقّق ذلك إلا بتجاوز مناخ الاستقطاب الحاد الذي يقوم بتوظيف هذه المراجعات في عمليات دعائية أقلّ ما يقال عنها أنها رديئة ومبتذلة.
- إطلاق حالة حوار حقيقية وبنّاءة: أنا أدرك أن كلمة الحوار قد استُهلكت وأصبحت مبتذلة في نظر الكثيرين، ولكني أعلم أيضًا بحكم تخصصي وخبرتي في تصميم عمليات الوساطة والحوار، أن ما يُطلَق عليه حوارٌ ليس كذلك في حقيقته؛ وإنما هو مجرّد توظيفات سياسية رديئة لعملية لها شروطها ومتطلباتها التي لم يحرص أحد على توفيرها.
- فاعلون اجتماعيون ونخب واعية قادرة على المساهمة الفاعلة في إحداث هذا التجديد، بما تملكه من خبرات ومهارات وانفتاح على العالم، وقدرة على ترجمة التصورات والرؤى إلى برامج وسياسات قابلة للتطبيق.
- وجود هياكل سياسية قادرة على الاستفادة من هذه المراجعات القيّمة، وتحويلها إلى سياسات وبرامج عمل ملموسة.
إن استعادة السياسة بمعناها الحقيقي ستجعل من المراجعات صفة ملازمة لحياتنا كلها. فالسياسة، في أحد جوانبها، هي عبارة عن بدائل متنافسة، ولن يتحقق لها ذلك إلا من خلال النقد البنّاء لبدائل السلطة والمعارضة، ممّا يدفع أصحابها إلى المراجعة الذاتية كمقدّمة ضروريّة للإصلاح والتغيير نحو الأفضل.
